يتفِّقُ أغلبُ الدارسين المُحدَثين على أنَّ الممارسة النقدية العربية، أضحت اليوم مطالبة -لاعتبارات عديدة-بضرورة تجاوز تلك المناهج التقليدية العتيقة في نقد الأدب وتحليله، والتي ظلت مشدودة ردحا من الزمن حدّ الفتنة، إلى ثوابت كثيرة، لعل أهمّها سيادة الانطباعية والأحكام القيمية المستنِدَة إلى مفاهيم مُتَجاوَزَة. يُضاف إليها-في أحيان غير قليلة- هيمنة الذائقة الشخصية للناقد- دون سند معرفي متين وأدوات إجرائية واضحة- على تحليل النصوص ومقاربتها، وإيلاء أهمية كبرى لخارجيات النَّص من ظروف اجتماعية وملابسات تاريخية وتوجهات إيديولوجية- على الرغم من أهميتها- وعدم إنصاتها لما يقوله النص، وإغفالها- بمقتضى ذلك- لما أفرزتهُ التجارِبُ النقدية والأدبية عند غيرنا، بل وحتى في تراثنا. بالإضافة إلى التشبُّث ببعض التحليلات الآلية للنصوص واعطائها سلطة أكبر، واتخاذها عقيدة لا ينبغي الحياد عنها مهما كانت الظروف. مما تحولت معه كثيرٌ من المقاربات النقدية إلى مجرد كشوف بيانات واستمارات تُملأ من قِبَلِ الناقد بحسب المنهج المتَّبع، فوجدنا أنفسنا -والحال هذه-أمام نصوص مختلفة ومقاربات متشابهة إلى حد التطابق
اللغة العربية وآدابها
الخطاب السيميائي في النقد المغاربي نظرية غريماس
20,000 $
يتفِّقُ أغلبُ الدارسين المُحدَثين على أنَّ الممارسة النقدية العربية، أضحت اليوم مطالبة -لاعتبارات عديدة-بضرورة تجاوز تلك المناهج التقليدية العتيقة في نقد الأدب وتحليله، والتي ظلت مشدودة ردحا من الزمن حدّ الفتنة

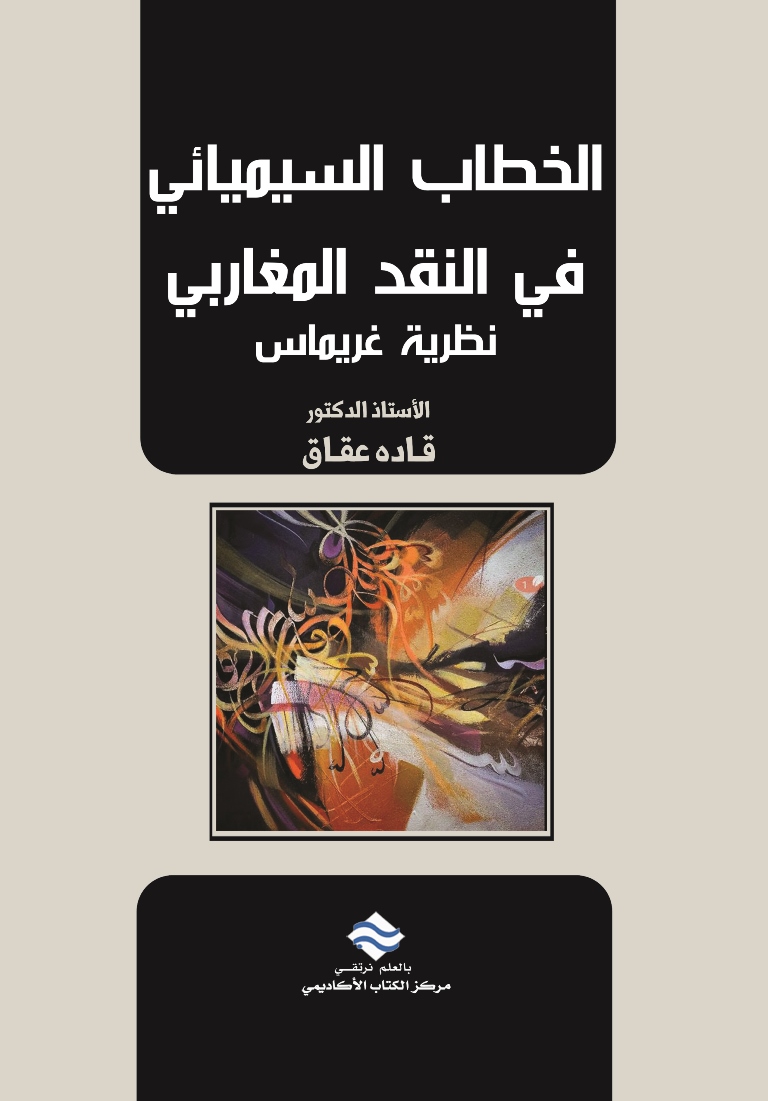
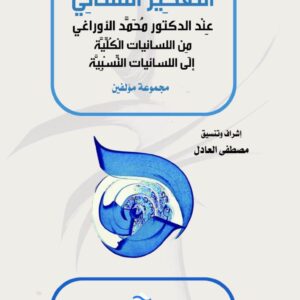
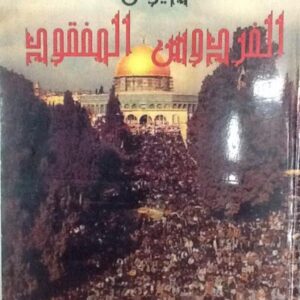
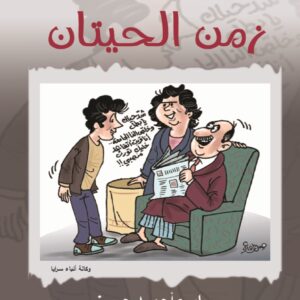
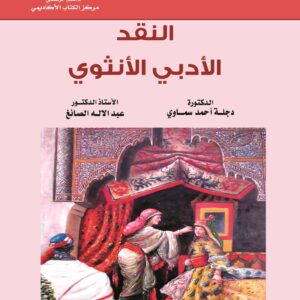
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.